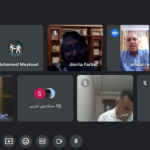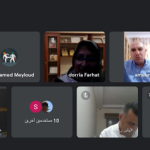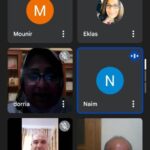مناقشة “سردية المعنى – أرض الزئبق” لنعيم تلحوق
تقديم وإعداد هاني سليمان الحلبي
برعاية اتحاد الكتاب اللبنانيين، دعا مركز حرمون للأبحاث وندوة حرمون الثقافية لندوة مناقشة من بُعد على منصة غوغل ميت، كتاب الصديق الشاعر الزميل نعيم تلحوق “سردية المعنى أرض الزئبق”، يوم السبت في 12 آب 2023.
ولبّى المناقشون: أمين عام اتحاد الكتاب اللبنانيين الدكتور الياس زغيب، الأستاذ الدكتور رضا عامر، الدكتور عمر شبلي، الأستاذة الدكتورة درية كمال فرحات، الدكتور منير مهنا.
وعقب على المداخلات المؤلف نعيم تلحوق بكلمة شكر.
وحضر لفيف من الأصدقاء والمهتمّين.
الحلبي
وأظن أنكم ستستفيضون في الحديث عن الكتاب موضوع المناقشة، بما يليق بالكتاب وبالشاعر المؤلف، وحقيقة قد يأتي وقت يقال لنا فيه مبارك لكم، أن يكون في لغتكم القرآن الكريم، والمتنبي، وابو العلاء المعري، وابن خلدون، كتاب النبي لجبران، وكتاب نشوء الأمم لأنطون سعاده، وسردية المعنى لنعيم تلحوق..
وأرغب ان الفت أنظاركم إلى نص النداء الهام الذي اطلقه اتحاد الكتاب اللبنانيين منذ أيام قليلة ويشكل رسالة تعبر عن المثقفين كافة، والتزامهم الوطني والقومي
وجاء في النداء ما يلي: “الى اللبنانيين الغيارى على وطنهم لبنان، وطن مقاومة كل محتل وغاز ومستعمر، وطن الكلمة والحرف والانفتاح، بل وطن الانتصار على الأعاصير كافة، وهو لكل ذلك، اتخذ شجرة الأرز، بكل عنفوانها وقوتها وديمومتها واخضرارها، شعارا لعلمه. اليكم هذا النداء الوطني، وكلنا ثقة أن ما يعتمل في نفوسكم هو أعمق وأقوى وأثبت من كل الكلمات.
1- الحفاظ على وحدة لبنان وتنوعه
ان قوة لبنان الحقيقية، ليست بما يملك من ثروات طبيعية، وهي غنية جدا قياسا بمساحته الجغرافية الضيقة، انما الميزة الأساس والعامل الأبرز لقوته هما تمكنه من الحفاظ على وحدته وعلى تنوعه. ومن واجبنا كمثقفين ونخب فكرية ان نعلي دوما من قيمة وحدتنا وتنوعنا، لأن الأعداء يستهدفون هذه الوحدة وهذا التنوع، وفي مقدمة من يستهدف ذلك هو العدو الصهيوني، الذي يطمح الى قيام الدولة اليهودية بمفهومه الصهيوني.
2- التصدي لمحاولات زعزعة القيم الإنسانية الفطرية والأخلاق الحميدة ومضامين الرسالات السماوية
3- في الحفاظ على التربية والتعليم بجناحيه الرسمي والخاص.
وخلص النداء إلى أن يختم: “اننا في اتحاد الكتاب اللبنانيين، على ضآلة مواردنا لدرجة الانعدام، وعلى ضعف امكانياتنا، نثق ان الشعراء والأدباء والمفكرين والباحثين وأهل الرأي وأرباب الحرف والقلم، قادرون ان يتصدوا وأن يصححوا وأن يمنعوا وأن يحولوا دون الانزلاق الى القاع السحيق. وإننا ندعو الى اعلان حالة طوارئ تربوية وثقافية يشارك فيها مثقفون وتربويون يغلبون المصلحة العامة على مصالحهم الفئوية الضيقة.
عشتم وعاشت الثقافة الحضارية وعاشت القيم الأخلاقية وعاش لبنان”.
الممتلئ بفكر انتصار الإنسان
الدكتور عمر شبلي
(شاعر وناقد ورئيس تحرير مجلة المنافذ الثقافية المحكمة)
صديقنا وشاعرنا نعيم تلحوق الذي نحبّه منذ البداية يجعل الرواية حدثاً شعريّاً، فالحدث عنده وليد الرؤيا لا الرؤية. وهو بهذا يحاول أن يحوّل الحدث إلى صياغة ومَن الذي يستطيع أن يجعل الحدث الروائي شعراً إلّا الصياغة، لأن الصياغة في الأدب هي لغة اللغة، إذ تغسل الصياغة المتمكّنة اللغة من قاموسيتها المحدودة وتنقل محدودية الرؤية إلى آفاق الرؤيا ومدياتها اللامتناهية. فاللغة متمادية وخارجة على القولبة، ولذلك غدت المرأة أرض الزئبق هي الفكرة والصورة والضوء عند صديقنا نعيم تلحوق وهي مَن اخترع الوجود، إذن هي خالقة، وهو يتفق مع الشاعر بدوي الجبل في قصيدته “خالقة” التي تغنيها فيروز، حين يقول بدوي الجبل مخاطباً حوّاءه خالقته:
فكيف أهملتِ قلبي من تجلّدِه
لمّا تَوَلَّيْتِ إبداعي وتصويري
وهل تريدين روحي هدْأةً ووَنىً
فكيف أنشأتِ قلبي من أعاصيرِ
شاعرنا يؤلّه الأنثى رغم حرائق جسدها المصنوع من حمأ مسنون: “أليس الله أنثى؟!” كما يقول شاعرنا نعيم تلحوق، وأروع ما في ألوهة الأنثى أنها أنثى، أولم يشرق الفجر على أنثى “وإذا صبيٌّ صغيرٌ نائمٌ في حضن مريمْ”.
الشاعر في داخل نعيم تلحوق يتغلّب على ماركس وعلى الفيلسوف الوجودي وعلى العلماني والسبب هو علاقة الشعر بالحرية والحب. ولعل الشعر هو الكائن الأول في ماهيّة الإنسان، وأعتقد أن آدم رثى ابنه هابيل بالشعر. إذ كان لا بد من الرثاء. ويخطئ بتسطحٍ مفرط في سطحيته من يعتقد أن الشعر إلى زوال. فالشعر ملازم لبقاء الإنسان. وقد يكون الشعر قصة كما رأينا في نتاج جبران خليل جبران، وكما نرى الآن في أرض الزئبق عند شاعرنا نعيم تلحوق. فالحدث في أرض الزئبق يُصاغ شعرياً والكلمة عنده تلبس حجاباً يُغرينا بالكشف ويخلق فينا الدهشة.
القلق يستبدّ بشاعرنا في كتابه “أرض الزئبق”، والقلق في الإنسان هو شعر وهو أعلى حالات البحث المعرفي لأن الأسئلة الوافدة من القلق تلغي الأجوبة الوافدة من اليقين.
كان شاعرنا نعيم تلحوق جوّانياً حتى رحيق روحه الأخير بعكس ما قال ص ٣٩. هو يقول: “كنت مشهديّاً أكثر منه جوانياً، وقد جعلتني الأورام البشرية أحتار في إنسانيتي”. أنا أرى أن يأسه من الأورام البشرية هو الذي جعله يغوص في الشكل المشهدي ليصل إلى عالمه الجوّاني النقي الذي يرفض مشهدية التناقض ليكون ناقداً تغييرياً. والتغيير والتغيُّر ينبعان من جبال عالمه الداخلي النقي. ربما كان شاعرنا ينظر الى كلمة “الجوانية” بمعنى آخر. إنما أنا أسأل شاعرنا المجيد كيف ترى الأورام الخارجية من دون بصيرة داخلية. فالبصيرة هي أبعد من البصر وأعمق رؤيا واكتشافاً.
في مقطوعة “آفة المعنى” ص ٧١ يحاول شاعرنا بقلق فكري وصياغي أيضاً ان يناقش فكرة وحدانية التألُّه أم كونيته، فقط اريد أن أقول كما قال رهين المحبسين أبو العلاء المعرّي: “إنّ التألُّه موجود في الغرائز”، والحقيقة التي يراها أبو العلاء وغيره هي أن الضعف في المخلوقات هو حتمية الإقرار بقوة مطلقة تتعامل مع ضعف المخلوق واحتياجاته التي لا تنتهي. حتى المؤمن بتفرّد ملكية الله هو كالآخر الكوني المؤمن بوحدة الوجود من محي الدين بن عربي والحلاج وما قبلهما إلى جبران خليل جبران وما بعده القائل في كتابه النبي: “إذا أحب أحدكم فلا يقل إنّ الله في قلبي، بل فليقلْ أنا في قلب الله”، وفي قوله أيضاً: “حتى يصبح الإنسان إلهاً”.
أما في قضية المعركة الدائرة منذ الأزل بين الله والشيطان فمكانها وكل أبعادها قلب الإنسان وفكره. والنقاش الذي دار بين الله والملائكة في سورة البقرة وغيرها: “إني جاعل في الأرض خليفة” هو تفسير لثنائية المخلوق وتقلبه بين الخير والشر.
الشيطان مستمرّ في عناده وسيبقى لأنه امتداد لكينونة الإنسان.
يقول جان بول سارتر معبراً عن هذا الصراع في كتابه “بودلير شاعراً”: “إن الشيطان المقهور الساقط المذنب المفضوح من قبل الطبيعة كلها القابع في الدرك الأسفل من مراتب الكون المرهق بذكرى الغلطة التي لا كفارة عنها، الذي تتآكله صبوةٌ غير مشبعَة، والذي تخترقه نظرة الله التي تُحَجِّره في ماهيته الشيطانية المرغم على أن يتقبّل حتى في أعماق نفسه بتفوّق الخير. إنّ الشيطان هذا ليتغلّب على الله نفسه سيده وقاهره بألمه، بتلك الشعلة من عدم الرضا الحزين التي تلمع في اللحظة التي يقبل فيها بهذا الانسحاق بالذات كتوبيخ لا تكفير عنه. إنّ المقهور هو الذي ينتصر في النهاية”.
كتاب أرض الزئبق غنيٌّ مملوء بفكر ينتصر فيه الإنسان على كل ما يعيق إنسانيته، ولكن بمائدة شاقة أتقن شاعرنا نعيم تلحوق التعبير عنها بعمق.
أرض الزّئبق لنعيم تلحوق وفق عتباتها ورؤيتها وطرائق السّرد
أ.د درية فرحات
(ناقدة وقاصة وأستاذة جامعيّة ونائبة رئيس تحرير مجلة المنافذ الثقافية المحكمة)
أرض الزّئبق رواية الكاتب نعيم تلحوق تقودنا إلى البحث فيها من زوايا عديدة، سواء اختلفنا مع بعض ما ورد فيها من أفكار، أو توافقنا.
وننطلق بداية مع العتبات النّصيّة التي اهتمّت بها الدّراسات السّيميائية، فكانت دراسة مجموع النّصوص التي تحيط بمتن الكتاب من جميع جوانبه: حواشِ وهوامش وعناوين رئيسة وأخرى فرعية وفهارس ومقدمات وخاتمة وغيرها من بيانات النشر المعروفة التي تشكّل في الوقت ذاته نظامًا إشاريًّا ومعرفيًّا لا يقلّ أهمية عن المتن الذي يحيط به، بل إنّه يؤدّي دورًا مهمًّا في نوعية القراءة وتوجيهها، والعنوان من أهم النّصوص الموازية للنّص إذ أنه أوّل ما يصافح بصر المتلقي وسمعه.
ومن هنا يمكن القول إنّ العنوان هو من أهم العتبات النّصيّة التي توضّح دلالات النّصّ، واكتشاف معانيه الظّاهرة والخفيّة، من خلال التّفسير والتّفكيك والتّركيب، وعليه يُشكّل العنوان المفتاح القادر على فهم النّص، وسبر أغواره. وقد حدّد جيرار جينيت وظائف عديدة للعنوان، منها الوظيفة التعيينيّة/التسمويّة، والوظيفة الإغرائيّة، والوظيفة الوصفيّة والوظيفة الدّلاليّة الضمنيّة، وقد تتحقّق هذه الوظائف كلّها في عنوان واحد، بحيث يصف المحتوى، ويُوحي بأشياء أخرى.
من هنا فإنّ “أرض الزّئبق” عنوان يُغرينا في البحث عن جدواه، بداية كلّنا ندرك أنّ الزّئبق هو عنصر موجود طبيعيًّا في الهواء والماء والتّربة، وقد يسفر التّعرّض للزّئبق آثارًا سامة على الجهازين العصبيّ والهضمي. وإذا كان هذا هو التّعريف العلميّ للزّئبق، فإنّه من المتعارف عليه أنّنا بتنا نطلق لقب الزّئبقي على كلّ من يصعب الإمساك به، أو للدّلالة على التّهرّب، وهذه الزّئبقية أو الشّخصيّة الزّئبقيّة مصطلح اشتقّه بعض الباحثين من اللقب الذي اكتسبه علي الزيبق لأنّه كان رمزًا للقدرة الفائقة على المراوغة والمرونة واستيعاب المتغيّرات إضافة إلى صفات أخرى كالمكر والدّهاء والخداع، وعليه فالزّئبقيّة هي حالة سيولة مستمرة في الفكر، يمكن التعامل معها انطلاقاً من أصالة الفكر، لكن في الإنسان من الصعب السيطرة عليها مع بقاء الإنسان أصيلاً في وجوده.
وهذا ما يحفّزنا أن نتساءل عن أي أرض زئبقيّة يبحث الكاتب القائل في روايته “أنا هنا يا حبيبي، “لؤاك” بين محارتين، أن تكون زئبقًا أو ماءً، ترابًا أو هلامًا أو هيليوم الضوء، شعاعًا أو نورًا أو هواءً؟!!”. ونتساءل عن القضايا التي تثيرها الرّواية، بدءًا من الإهداء نستلهم البحث عن المعنى واللغة، فيكونان الأم الأب، ومنها نستلهم البحث عن الطّفولة، وعن الحقيقة وعن الوجود. وكما جاء في الرّواية “كأنّي في هذه الرّواية أقول كلّ شيء ولم أقل ما أريد قوله تمامًا”. وبين البحث عن المعنى واللغة تطرح الرّواية قضايا وجوديّة ترتبط بحقيقة وجودنا “”أنا أتطلّع إلى اليقين، إلى الحقيقة، إلى وجوب الوجود لا إلى ممكنه”. وفي البحث عن اليقين قد تتجاوز الرّواية كلّ الخطوط، أو لا تقف عند أي حدود فما تريد أن تصل إليه إلى أنّ الثّابت الوحيد هو التّطوّر، فلا “ثوابت في المادة الحيّة… حتى العلم الذي يبحث عن الحياة غير ثابت…”.
وتأخذنا الرّواية إلى عوالم متعدّدة أولّها عالم المرأة، إن كانت بما تمثّله أو بما رمز إليها الكاتب وبما أراده، وإن كانت لؤى هي الأبرز في الرّواية، لكنّنا نرى أسماء عديدة لنساء مختلفات، يتقلّب معهن البطل ويعيش مواقف مختلفة، وكأنّ عدم الثّبات يكون في عدم الثّبات مع امرأة واحدة، أو الموقف الواحد.
ويقطف الكاتب من كلّ بستان زهرة فيشير إلى قضايا سياسيّة واجتماعيّة واقتصاديّة وأدبيّة متعدّدة، ومن أهم ما يشير إليه إيمانه بأنطون سعاده وبمبادئ حزبه، ونبحر في الرّواية مع آراء متعدّدة لأدباء وفلاسفة وفنانين، ويربط ذلك كلّه بقضية الرّواية المعنى واللّغة.
والخط الثالث الذي تثيره الرّواية ويرتبط بالخط الأساسي هو البحث عن هوية هذا العمل الذي بين أيدينا، هل هي رواية أم ماذا؟ وقد أشار الكاتب في مقدمة عمله إلى هذه الإشكالية.
والقارئ لهذا العمل يتساءل هل يصنّفه ضمن السّيرة الذّاتيّة، خصوصًا ما رأيناه في العمل من عودة دائمة إلى الطّفولة، وتبيان ما تركه الأب في صاحب السّيرة، وما تركته الأمّ أيضًا، وينطلق من هذه المواقف لتكون شاهدة على إشكاليته الأساسيّة.
وقد نتساءل هل نصنّف هذا العمل ضمن التّحليل النّفسيّ ونظريّات علم النّفس، وما تتركه من آثار على السّلوك والتّصرّفات.
وقد نتساءل هل تكتمل العناصر السّرديّة في هذا العمل، فقد عمد الكاتب إلى استخدام تقنيّات السّرد الزّمنيّ من استرجاع واستباق وتضمين. ويمكن القول الكاتب قد اعتمد من طرائق السّرد طريقة المونولوج أو تيار الوعي، وهي طريقة تولي التّفكير الذي يشغل بال الشّخصيّة ويستحضر ذكرياتها، كيفما وردت إلى الذّهن ليجعلها مادة لرسم الرّؤية التي يقدّمها، ولا يشترط في هذه الطّريقة التّرابط المنطقيّ أو التّتابع الزمنيّ للحوادث، لأنّ التّركيز يتّجه إلى التّموّج والتّدفّق العاطفيّ وتداعي الخواطر والذّكريات، ومن الطّبيعيّ بأنّ ما يثير هذه الخواطر والذّكريات ويستدعيها، هو حركة بطل الرّواية وطبيعة تفاعله مع الآخرين. وهذا ما وجدناه في هذه الرّواية، فكانت أشبه بمنولوج نفسيّ داخلي، بل إنّ الكاتب أوجد في داخل النّفس أسماء عديدة لنساء شاركنه في عرض ما يجول في النّفس.
وفي سياق هذا الأمر نرى الكاتب يعتمد الكثير من إيراد الحقائق والوقائع الحقيقيّة، ويقدّم رؤية فكرية لكثير من القضايا الثّقافيّة، بل أنّ يعرض لآراء العديد من الشّعراء والمفكرين والأدباء. وكأننا هنا نذهب إلى ما يسمّى التناصّ التّضمينيّ، وما يؤدّي إلى تداخل النصوص، ونراه يتناص أيضًا مع الأسطورة والحديث عن الأنوناكي وهي مجموعة من الآلهة التي تظهر في الأساطير التّقليديّة للسّومريين والآشوريين والبابليين.
وأيضًا هذا يدفع المتلقي إلى السّؤال هل يصنّف هذه الرّواية ضمن الواقعيّة، لكنّه يرى أنّ الكاتب يعتمد شيئاً من العجائبيّة أو ما أطلق عليه النّقاد الأدب الفانطاستيكي الذي يستند إلى تداخل الواقع والخيال، وتجاوز السّببية وتوظيف الامتساخ والتّحويل والتّشويه ولعبة المرئي واللامرئي، من دون أن ننسى حيرة القارئ بين عالمين متناقضين: عالم الحقيقة الحسيّة وعالم التّصور والوهم والتّخييل، فكان مزجه بين الواقع وبين عالم المخلوقات الفضائيّة.
وقد وُسم العمل بأنّه رواية، وقدّم لنا الكاتب في مقدمة عمله رؤيته لمفهوم الرّواية، ويختصر هذه الرّؤية بقوله “إنّ الرّواية الحقيقيّة هي نبض خيال من واقع إلى خيال، إلى استثمار ذكيّ للشّعر والفلسفة والعلوم قاطبة والاستعانة بمخلوقات فضائيّة مؤنسنة لتستجيب حركتها العلميّة والأدبيّة والخرافيّة والسّحريّة والمخلوقات الحيّة التي ترعش في الفضاء الذي تنتمي إليه… هي وجودك…”.
وهذا ما قدّمه الكاتب في روايته فكانت أرض الزئبق قادرة على تقديم رؤيته بما يحقّق هذه الزّئبقيّة المتخفّية بعالم الفضاء وإن أطلق عليها تسميات حقيقيّة.
في الختام شكراً لكم وشكراً للأديب نعيم تلحوق الذي قطع أنفاسنا، وكما بدأنا قد نختلف أو نتوافق معه في بعض الأفكار والآراء.
سرديّة المعنى: التحوّل والحلول
د. منير مهنا*
(أستاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية عضو لجنة مئوية الثورة السورية الكبرى)
في نصوص أرض الزئبق، يمتلك نعيم تلحوق السارد، لغة استثنائيّة لطالما كانت حاضرة في دواوينه الشعرية، فهو وإن غادر حقل الشعر، لكنّه لم يغادر لغته، أزاحها فقط من حقل الى حقل، وسار بها وبنا من أرض الأحلام الى أرض الزئبق، هي نفسها اللغة التي تكافئ قارئها بحساسية انتباه لمعاني الثنائيّات والمتضادات والمترادفات، يخرج بها في سرديّته عن مألوف الاختلاف والمقاربة الشعريّة الى حقل دلالي جديد يحاول أن يشكّله على إيقاع حدثه وأحداثه وتجاربه.
وفي لغة السردية التلحوقية نتذوق ونحن نقرأ نصوصه معنى الانغماس الذاتي في المُتع غير النهائية للمعنى. معنىً هو نفسه يفيض عن المعنى.
لست بناقد أدبي، ولا أدعّي إلمامي بالنقد ومنهجه، دون أن يمنعني ذلك عن ملامسة عتبة التذوّق المعرفي كمتلقٍ للنص، والكتابة عن تجربتي معه وحوله، لذا سأوجّه قراءتي ومداخلتي في اتجاهين متوازيين:
الأول: الأدب بوصفه فعل إنتاج وإبداع للرؤية، واصفاً للرؤية المحمولة في “سردية المعنى”.
الثانية: علاقة هذا الإنتاج بالتحوّلات المجتمعيّة التي يشهدها عصرنا المعولم والسيّال.
اولاً: الرؤية المحمولة في “سردية المعنى” من منظور إبداعي:
– تتقاطب الرؤية الناظمة لسردية المعنى على ثنائيّة: الأيروس (غريزة الحياة) والسانتوس (غريزة الموت)، وما بينهما يقف نعيم تلحوق محاولاً أن يفكّ اللغز الإنساني لمعنى الحياة، التي طالما أخفاها الإنسان عبر تاريخه في طيّات تاريخه الثقافي عبر أشكال مختلفة من الطقوس والتعاويذ، وألبسها المفاهيم التي تخفّف من وطأة وقع الحقيقة على الكائن البشريّ الهشّ في مجرى التحوّل من طاقة الأيروس وصراعها ضد طاقة السانتوس. من هذه الطقوس مثلاً أفعال البطولة والتضحية والفداء في الميثولوجيات، طقوس الحب ومعانيه في الشعر والفن والموسيقى، طقوس الاحتفالات ونشوة النصر أو الدعوة للانتصار على الألم. والأمثلة كثيرة.
لطالما طالب اللغز الإنساني بحقّه بالخروج من عباءة التعويذات التي استودعته الجماعة فيها، فمحته أحياناً وتحاذقت على إخفائه أحياناً أخرى، وتجاهلته كي لا تتعامل معه،… أمّا في “سردية المعنى” فنجد محاولة للكشف والبحث والتأصيل وإزاحات جريئة للتعاويذ عن جسد المعنى ولغته وشغفه وسقوطه. يقول تلحوق:
“نحن عالقون في منفى ذواتنا، الكلّ يتآمر على الكل، بما فيها نحن… العالم يتآمر على نفسه، ولا ندري حتى اللحظة، جنس واحد لم يتفق على تحقيق بشريته، فكيف به يدرك معناه؟! “(تلحوق، عبث اللغة، 113-114).
ويضيف: “الحياة بحاجة الى خطأة، ليستقيم صوابها.. وليست بحاجة إلى الكثير من الصواب ليتستقيم اعوجاجها”. (تلحوق، شغف اللغة، 105).
في تعريفها اللافت للكتابة تقول خالدة سعيد، “الكتابة هي لعب الإنسان مع الموت وليس موتاً. فالكتابة هي اختراع ضد الزمان والمكان، ردٌّ على محدودية الإنسان، إنها استحضار، استبدال لحاضر، التحرّك بعكس حركة الزمن”.
كيف تواجه الموت/المحو، أليست تلك هي المعضلة؟
– “….لقد تأكد لي قطعاً بأن الله هو لغة المحو لا إملاء فيها؟؟؟ الله هو المحو، والمحو هو المعنى…”.
ثم يضيف:
– “تعالي يا “لؤى” نجمع كل تعبنا لنغادر هذه الأرض، ونهرب من كل هذا العبث اللغويّ المنحل، لقد حيّرني ربي بما فعل… يبد أننا خلقنا كي لا نفهم شيئاً أبدًا… تعالي نجمع أحلامنا وأجسادنا ونغيب… إنها أرض الزئبق يا حبيبتي..”. (تلحوق، عبث اللغة، 125).
في كتاب “الطريق الى اللغة” يقول مارتن هايدغر: “العقل هو اللغة، واللغة تتكلم، العقل يكمن في اللغة”.
اللغة بيت الوجود، وفيها يتجلى المعنى، إن وجودنا رهن أي لغة نتكلم وأي معنى نحمّله في بواطن هذه اللغة لنصنع وجودنا على أساسها. لكن نعيم تلحوق لا يؤمن سوى بالمقولة الهيراقليطيسية الشهيرة: “كل شيء ينساب” فتراه يقول: “المعنى هو عصيان اللحظة دائماً وأبداً، أما اللغة فهي اجترار المرئي من الأوقات…”. (تلحوق، سقوط المعنى، 144).
مواجهة الأيروس والسانتوس في أرض الزئبق:
هنا نجد الحبّ يتكاثر في الانتماء إلى “الأنثى”، وتتعدّد الحبيبات والعاشقات المستولدات لغة الحياة من قلب لغة الموت، ويلعب نعيم تلحوق لعبة الخالق والمخلوق، نرى أسماء نساء وغوايات أيروسية.
– لؤى، لمار، ميرنا، حنين، نورا، رغد، مريم، ورد… وغيرهن من نساء “أرض الزئبق” مدعوّات الى وليمة الغواية التلحوقية ليقلن له الكلمات التي لا ينطقها العشاق “ساعدني على الحياة”.
ها رغد تبوح لصاحب أرض الزئبق، فتقول: “عَرَفتَ نساء كثيرات… أعلم ذلك!! لكنَّ الّتي عَرَفتكَ تخشى أن تراها… يا ملح الكتابة، خبَّئني، فقد تعبت، أخاف أن يتشوّه وجه الماء، يا أنا كم أشبهك، حاولت ألا أخشى ظهورك بي.. حاولت أن أمسك الوقت من أضلاعه… وأهمس: حان البدء بالأشياء لأصل إليكَ… وابتعد عن ترّهات الثقافة…”. (تلحوق، جسد المعنى، 128-129).
والمعنى لا يكتفي بحالة، يريد أن يكون هو “الحالة”، المعادلة البشرية أصعب من أن تحقق اكتفاءها وقد تكوّنت على قدرية العُنَّة: “العجزٌ الذي يصيبُ الرجلَ فلا يقدِر على الجِماع”، العُّنة/ اللعنة التي تتلاشى فيها القدرة على خلق المعنى، فتكون المعاناة. بين عُنّة، ومعنى، ومعاناة يقف الإنسان تائهاً في صراع الأيروس للحفاظ على وجوده مع السانتوس الزاحف إليه بقوة الإمحاء، وما بينهما قدر لا ينفكُّ عن تكرار معناه.
السردية وإضافاتها الأدبية:
“لكل كلام وجه وتأويل، ومن التمس عيباً وجده” (ابن رشيق).
من الجانب الأدبي/ الإبداعي، نرى نعيم تلحوق في نصوص” سردية المعنى “يقدم لنا بُعداً جديداً لمفهوم الرؤية السردية” كمفهوم نقديّ يتناول الخطاب السرديّ أو يتناول الطريقة التي اتبعها الكاتب في سرد أحداث قصتِهِ أو روايتِهِ، فالرؤية السردية تُعنى بالمكوّنات الخاصّة بالنص المسرود من حيث الشخصيات والأحداث والحبكة الأساسية في النَّصّ وما شابه ذلك،…..
وهي تتوزّع على ثلاثة مستويات: الرؤية من الخلف، الرؤية المصاحبة أو الملازمة، الرؤية من الخارج ” ([*]).
واستطيع ان أضيف اليها مستوى جديد هو “الرؤية من فوق” (أي قدرة السارد على معرفة الشخوص والمواقف والأحداث وكشفها وتأويلها بالمغازي الدّالة عليها، وليس بظاهرالمعاني).
ومثالها كثير اكتفي منه بذكر ما كتبه نعيم تلحوق “العالم يدفع بك الى الأمام لينزع عنك صفة الألوهة، ويحتّم عليك مشاهدة الأشياء من فوق….” (تلحوق، انحناء المعنى، 68).
وكذلك في الفصل الأخير من سرديته “سكون المعنى” ص 157، يقول:
– “لا أعرف أين كان الشعراء، يا “منار” كانوا يتغزلون بأنفسهم، ونسوا كيف يتمّردون، التمّرد شيء آخر غير الثورة… كانوا مزروعين خلف تعاليمهم المختلفة، وحين جاءت الثورة جرفتهم، وقرروا أن يدخلوا كنهها، فخربوا البلاد والعباد، وقسّموا المجتمع الى فئات، وصار همّهم كيف يحصّنون مواقعهم على حساب أفكارهم…”.
ثانياً : قرأة التحولات المجتمعية في نصوص “سردية المعنى”.
في سردية المعنى نقرأ نتاجاً فكرياً يعمل على إعادة “تشكيل الذات” في عصر يعمل على “محو الذات”.
في زمن يتّسم بشكل متزايد بتفكّك أنظمة المعتقدات وأنظمة الانتماءات…. حيث يعمل الكثير من المنتجين الجدد للأفكار والتقانة على التخلّص من كل ما يُعيق تأكيدهم على القيم الفرديّة والنفعية، متّجهين بفكرهم الى عصر “استبداد الفرد”. وهو ما أشار إليه كتاب “الأزمنة السائلة” أو “العيش في زمن اللايقين”. لعالم الاجتماع البولندي زيجمونت باومان (1925-2017)
والأزمنة السائلة في تفسير “باومان” هي حياتنا المعاصرة التي تعاني من تحوّل في هياكل المجتمعات من الصلابة إلى السيولة – كما هو معتاد – وهي التحولات التي يرى “باومان” بدايتها من تفكك الأبنية المجتمعية والمؤسسات التي تضمن العادات المجتمعية وأنماط السلوك، والتي لم تعد قادرة على الحفاظ على عادات المجتمع وسلوكه لفترات طويلة كما السابق، وهو ما أدى إلى “ارتفاع رصيد المخاوف نتيجة غياب التوقع وتآكل العرف ومنظومة الأخلاق الاجتماعية”.
ثم ينتقل “باومان” إلى الانفصال الحادث بين السلطة (ما نستطيع فعله) والسياسة (ما ينبغي أن نفعله) بما يفصل أهداف أفعالنا عن أفعالنا ذاتها وهو النتاج الفعلي للاستهلاك بلا غرض نهائي.
أمام هذه الإشكالية يأتي نتاج نعيم تلحوق الفكري ليتموضع ويستكمل مسيرته في الردّ على الانتقال من الزمن الذي تعلو فيه القيمة على المنفعة الى الزمن الذي تنحطّ فيه القيمة وتعلو المنفعة. الزمن الذي تتشيّأ فيه القيم، وتتقيّم الأشياء.
يرى نعيم تلحوق أنه في مثل هذا العالم المتشيئ يُعاد تشكيل المعنى خارج أي معنى. وينقلب اللامعنى على المعنى، يتفكك الزمن المرتبط بالحدث والذاكرة الى زمن يمحو فيه التسارع في صنع الحدث وتدفقه قيمة الحدث نفسه، تموت ذاكرة الزمن ويولد زمن النسيان، ويدخل الكائن الإنسانيّ هذا التيه بلا علامات تربط ماضيه بحاضره وبغائية وجوده ومستقبله، بلا يقين الى أين يتجه سهمه، والى أين تندفع خطاه. فيسقط في الخوف من عالم لا أمان فيه ولا ثبات.
بالتأكيد، إن استبعاد “الأنا الطبيعية” لن يلغي وجودها، والمشكلة في إيجاد السبل للتعاطي معها وتحويلها من “أنا استحواذية” لتصبح “أنا إجتماعية”. وهذا ما يحاول نعيم تلحوق إظهاره وتبيانه.
صحيح أن السردية التلحوقية تقدم لنا مدونة لانشغالات الذات على امتداد نصوصها، لكنّ “الذاتي” عنده ليست “ذاتية متفردنة” بقدر ما هي “ذات مجمعنة” تجد مداها ومأواها في الـ “نحن”، والـ “نحن” المعنية بها الذات التلحوقية ليست سوى جماعة مثقفي النهضة والحداثة، أولئك الفئة من النهضويين المخيّبة آمالهم ويعانون من قسوة تجاربهم وفشل رهاناتهم، ولكنهم رغم ذلك ما يزالون يملكون إيماناً بالمعنى لم يُسقطه الواقع الراهن، ويراهنون على مستقبل تُعيد فيه الذات تشكيل وعيها على قواعد جديدة لا تقبل الخضوع لسلطة خرجت عن واقعيّتها وأنقلبت على وعيها بنفسها.
وفي هذا السياق يؤكد نعيم جدلية الانتماء والولاء عند المثقف الثابت على مبادئه، “لم أشعر أن وطناً يولد في داخلي الا حين قرأت أنطون سعاده، مخلوق فضائي جاء من أقصى الجهات في الأرض، ليتيمّم بماء الخذلان وتراب اللغة وهواء السّم الزعاف، ونار متقدة لم يزل اشتعالها مستعراً حتى اللحظة…
فاشترى عذاباته بالدم وراح ينثر أفكاره ومراميه في حقول لم تصل لمكنون العالم الثالث بعد، لتحظى بإنسانيتها… كان إنسان المابعد في استحضار رعشة الخلق، كي يُعيد صياغة عالمه وأحلامه”. (تلحوق، ثبات المعنى، 87).
– المثقف/ النموذج اسمه خليل حاوي، النموذج عن النحن… يقول نعيم تلحوق على لسان مريم: “أخبرني عن مخلوق فضائيّ كسر القاعدة، مثقف شجاع عرف متى يخسر وكيف؟ اسمه خليل حاوي… اخبرني عن آخر يا طائر الفينيق؟! – (تلحوق، سكون المعنى، 156).
الكتابة عن هذه المتاهة في الدوران بلا هدفية أو اتجاه في الحياة، هي المغزى الأعمق للفضاء الذي يريدنا نعيم تلحوق أن نعيه في “أرض الزئبق”، متاهة لا يستقر فيها معنى أي شيء على معناه حتى يغادره الى معنى آخر، متاهة الأفعال والانفعالات المنحلّة والمتحلّلة عن روابطها وثوابتها.
في أرض الزئبق، نجد شهادة على أهمية أن تعود الدائرة الى نقطة البيكار، وأن نتمكن من إلقاء المنطق على الروح، وأن “نتدرّب على الموت” لكي نستعيد قدرتنا على الفلسفة، كما يقول أفلاطون.
والخلاصة: المبدع صنو المعنى، وصيرورته في أن يعي صنوه. أمام هذا الفيض من الشذرات الصوفيّة التي بثّها نعيم تلحوق في أرض الزئبق، نتلاقى مع “نيتشه” القائل: “لا يجوز أن نخدع أنفسنا مثلما لا يجوز أن نلتقي بالحقيقة بصورة عابرة”.
أختم قولي مستعيناً بكلمة/ موقف، هي أخر كلمة نطق بها الامبراطور ثيودوسيوس في حياته وهو على فراش الموت “Delixi”، نعم “أحببت”.
وتلت الندوة تقديم شهادات تقديم مداخلات للمناقشين وشهادات حضور للحضور الكريم.
[*] – https://sotor.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8B%D8%A7/