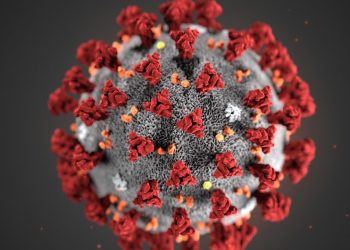راتب سكر*
فتحت عيني الصغيرتين على الوجود الواسع منتصف الخمسينيات في غرفة بسيطة تستند إلى الجدار الغربي لمسجد عبد الله بن سلام في حي باب القبلي المطل من تلته العالية على نهر العاصي في مدينة حماة.
سرعان ما حملني والدي مع الأسرة إلى أمكنة عمله المتنقلة، ينحت الحجر القاسي ويبنيه في جبال لبنان ومدنه. لم يكن انتقاله مع رفاقه النحاتين الآخرين إلى لبنان بحثاً عن فرص العمل فقط، فقد كانت تقلبات الأيام وسياساتها الملونة تفعل فعلها في تهجير أولئك الرجال الأشداء السمر من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة، وجاءت أسماء أولادهم تحمل وشم تلك الأيام ووشي أسرارها، فأخواي اٍلأصغران (أنور وجهاد)، وغيرهما من أبناء أولئك الناس، (أكرم، ورشيد، وجمال، وناصر، وخالد، وعمار، وسلام، وأنطون، وسعادة، وأليسار، وهنيبعل، وعصام، وكميل)، إنها أسماء تحمل على أجنحة حروفها أحزاناً وأفراحاً كثيرةً تفيض بقسوة صراعات موشومة بذاكرة الأيام، ومودات ريانة بمفردات ألقها ونورها.
كان ذلك الوالد يعود من عمله كل مساء مجللاً بغبار المقالع والحجر، فيلوّن أمسيات الأسرة بموسيقى الصخور ومرايا الأيام، يتحدث عن سفره عسكرياً بسيطاً في جيش الإنقاذ عام 1948، وقتاله مع أقرانه في التلال القريبة من مدينة صفد، ولقائه في تلك التلال الساحرة مع مجاهدين يعرفهم من مدينته حماة. ويتوقف طويلاً عند عام 1956 وتزاحمه مع أمثاله من الشباب العرب إلى السلاح التشيكي والالتحاق بالمقاومة الشعبية لمواجهة الغزاة في كل مكان أيام حرب السويس.
ذلك الماضي البعيد، جبل طفولتي بعناد مبهم في التعامل مع الأحداث، حتى إذا عبرت صغيراً سنوات الوحدة، توقفت عند يوم 28/9/1961، حين حذرني اللحاق به إلى منزل قريب اجتمع فيه مع إخوانه الحمويين المقيمين مثله في “إنطلياس” بلبنان، غير أني خالفته لأسمع كلمة الانفصال وسط نفث الدخان المتصاعد من احتراق السجائر العربية اللف الكثيرة. وتحملنا عربات الأيام إلى يوم 9 حزيران 1967، لأدخل البيت فأجده أمام شاشة التلفاز مع واحد من أصحابه، وبريق دموع يكتب في وجهيهما المقدّسين أسراراً، وهما يصغيان إلى عبد الناصر يقدم استقالته الشهيرة، حتى إذا جاءت ليلة 28 أيلول 1970، هزتني يدا أمي الرخصتان من نومي الهادئ لأرى عينيها منكسرتين وغائرتين في حزن أعمى، تقول لي: أبوك قرب المذياع حزين، كُن بجانبه، إنهم يذيعون القرآن ويقولون: عبد الناصر مات.
تلك صور من التراب الأرضي الذي جبلني إنساناً أتنقل من متراس إلى متراس، أحضر ندوات الأحزاب وأقرأ مجلات المنظمات الفلسطينية، منقلاً خطاي بين وادي العاصي المسكون بشياطين الشعر والأساطير، وشوارع بيروت وتلال جبال لبنان المكتظة بالأحلام وأشجار الصنوبر والبشر، ومتقياً أذى المتخابرين وفتوات الحارات وأشباههم، بما ملكت يداي الصغيرتان من نَدّ وبخور.
تركتُ الدراسة النظامية وعملتُ في ورش البناء قبل أن أتحوّل إلى صانع للحقائب الجلدية طوال سنوات رسمت على جبيني أسى الأسواق والمنافسات، إلى أن جاء شاب التقيت به مصادفة في معرض للفنون التشكيلية تقيمه رابطة الشباب اللبناني في بيروت، اسمه /فوزي الحسيني/، نصحني بمتابعة الدراسة بعد انقطاع، ورسم لي خطواتي إلى مدرسة (الرسالة العربية) المسائية في حي البسطة، ولا أعرف اليوم بعد كل تلك الامتحانات التي تقدمت إليها في قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية في جامعة دمشق، وفي قسم اللغة العربية في الجامعة اللبنانية، وفي الدراسات العليا في موسكو، لا أعرف إذا كان فوزي الحسيني هذا إنساناً حقيقياً عاش معي ذات يوم وارتضيته أخاً وصديقاً، أو أنه مجرد وهم من أوهامي الكثيرة التي تنسج معظم ساعات يومي.
قابلتُ لجنة اختيار الأساتذة الجامعيين في سفارة الجمهورية اليمنية بدمشق صيف 1997، ووصلت إلى صنعاء أصولاً، وقد وجدتني بعد أربع سنوات من التنقل بين جبال السدة والنادرة وإب وعمران وأرحب وشوارع صنعاء وعدن، أتصالح مع طفولتي البعيدة التي اكتشفت صورها بمسراتها وأحزانها، مرسومة في (جنبيات) السابلة والأصدقاء، وفي عيونهم التي علّمتني إيقاظ أحلامي، لأمشي في ربى اليمن مطمئناً إلى ناره الحنون، فرحاً بأناشيد موداتها، مدركاً اختلافها عن نار الموقد الذي أشعله عبده سعيد في رواية (يموتون غرباء) لمحمد عبد الولي.
أقترب من حقائب السفر، عائداً إلى دمشق، بعد سنوات إقامتي الصنعانية (1997-2001)، أوسع مساحة للصور والأسماء، وأتوقف قليلاً عند اسم الشاعر الكبير /عبد العزيز المقالح/، باسطاً في مكوّنات وجداني المساحة اللائقة بمودته الباذخة، وأستاذيته الراقية (ومقيله) المترف بالصداقات لمثقفين وأدباء من اليمن وسورية ولبنان والعراق ومصر والجزائر والسعودية وعمان وليبيا وتونس، وغيرها. هذا المقيل مدرسة عربية من طراز فريد، نهلت منها ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، فعدت بمغنم يملأ نفسي بأصداء الوجود وأحلامه الواسعة.
مضى على عودتي من صنعاء نحو ثلاث عشرة سنة، منذ عام 2001، شغلت فيها غير مهمة علمية وثقافية في حماة وحمص ودمشق، وأضفت إلى قائمة أساتذتي وأصدقائي أسماء جديدة، وها أنذا أتنقل بين أبواب عام 2014 بهدوء، كي لا أوقظ شيئا من حزنه العظيم، باحثا عن الأقرباء والأصدقاء الذين أنتظر لقاءهم في هذه المدينة أو تلك، حاملاً سلة فرحي بالأسماء والوجود، مؤكدا عمق انتمائي إلى الأمكنة والأزمنة التي حدبت على تنقلي في شعابها الواسعة، مانحاً صور إقامتي العلمية مدة ستة أشهر من عام 2006 في جامعة القاهرة، ترتيباً خاصاً..
رفعت رأسي قليلاً عن الورق، فابتسمت لبلادي العربية الواسعة بخجل، كانت مثقلة بالحزن والشقاء والدم، قال لي صديق: هوّن عليك يا صاح!… هوّن عليك… فتظاهرت بالامتثال، وأجلت متابعة الكتابة قليلاً..
*راتب سكر (ولد 1953 م) شاعر ومترجم وأكاديمي سوري. من مدينة حماة. له العديد من الدواوين الشعرية وحاز الجائزة الثالثة في مسابقة اتحاد الكتَّاب العرب للشعراء، وتُرجمت قصائده إلى الأذربيجانية.